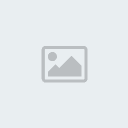
الخلاف بين العلماء - أسبابه وموقفنا منه
للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلِّم تسليماً.
{يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ
تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }. {يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ
رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ
بِهِ وَالاَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }.
{يأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَـلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً }، أما
بعد:
فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، وقد يسأل البعض: لماذا هذا
الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه؟ ولكن هذا العنوان
وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بالَ كثيرٍ من الناس، لا أقول من العامة بل حتى من
طلبة العلم، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثّها بين الأنام،
وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش، بل تشكيك عند كثير من الناس، لاسيما
من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف، لهذا رأيت ـ وبالله أستعين ـ أن أتحدث في
هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين.
إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأُمَّة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول
دينها ومصادره الأصيلة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية
وهو أمر لابد أن يكون.. وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي:
أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلّم أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلّم بالهدى ودين الحق، وهذا
يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد بيَّن هذا الدين بياناً شافياً
كافياً، لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها،
ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل، ورسول الله بُعِثَ
بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع
إليه فيحكم بينهم ويبيِّن لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله، أو فيما
يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبيِّناً
لها، وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: «يسألونك عن كذا»، فيجيب الله تعالى نبيّه
بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس. قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبَـتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }.
{وَيَسْـَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ
لَكُمُ الآيَـتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }.
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ
اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }.
{يَسْـَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن
ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَبِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
{يَسْـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـتِلُونَكُمْ حَتَّى
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن
دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـلُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالاَْخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ
}. إلى غير ذلك من الآيات.
ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم اختلفت الأُمَّة في أحكام الشريعة التي
لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها.
ولكنه اختلاف سنبيِّن إن شاء الله بعض أسبابه. ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا
يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دلَّ عليه كتاب
الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم عن عمد وقصد؛ لأن من اتَّصفوا بالعلم
والديانة فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومَن كان رائده الحق فإن الله سييسِّره له.
واستمعوا إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِن مُّدَّكِرٍ }. {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}.
ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى، لا في
الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابدَّ أن يكون؛ لأن الإنسان كما
وصفه الله تعالى بقوله: {وَخُلِقَ الإِنسَـنُ ضَعِيفاً}.
الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابدَّ أن يقع الخطأ
منه في بعض الأمور، ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم
في الأسباب الآتية السبعة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له،
والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي:
السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.
وهذا السبب ليس خاصًّا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومَن بعدهم. ونضرب
مثالين وَقَعَا للصحابة من هذا النوع.
الأول: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر
بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذُكر له أن فيها وباء وهو
الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم، فاستشار المهاجرين والأنصار
واختلفوا في ذلك على رأيين.. وكان الأرجح القول بالرجوع، وفي أثناء هذه المداولة
والمشاورة جاء عبدالرحمن بن عوف، وكان غائباً في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك
عِلماً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا
تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» فكان هذا الحكم خافياً
على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبدالرحمن فأخبرهم بهذا الحديث.
مثال آخر: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما
يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتدّ بأطول الأجلين، من أربعة أشهر وعشر...
أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عندهما وبقيت
حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت
في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: {وَأُوْلَـتُ الاَْحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
ويقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي،
وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا
طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن السُّنَّة فوق ذلك.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد
موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج»، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة
الطلاق التي تسمَّى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: {وَأُوْلَـتُ
الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.. وأنا أعلم علم اليقين أن
هذا الحديث لو بلغ عليًّا وابن عباس لأخذا به قطعاً، ولم يذهبا إلى رأيهما.
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق
بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، فأخذ بما يراه أقوى منه، ونحن نضرب مثلاً
أيضاً، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن في الصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله
عنها طلَّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة
العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم
فأخبرها النبي: أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها
نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملاً؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَـتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
عمر رضي الله عنه ـ ناهيك عنه فضلاً وعلماً ـ خفيت عليه هذه السُّنَّة، فرأى أن
لها النفقة والسكنى، وردَّ حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال: أنترك قول ربنا
لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من
التابعين، يقع أيضاً لمَن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى
يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل
العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها، ويراها الآخرون
ضعيفة، فلا يأخذون بها، نظراً لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه
وسلّم.
السبب الثالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجلَّ من
لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثاً، بل قد ينسى آية، رسول الله صلى الله عليه وسلّم
«صلَّى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسياناً»، وكان معه أُبي بن كعب رضي الله عنه،
فلمَّا انصرف من صلاته قال: «هلا كنت ذَكَّرتنيها» وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد
قال له ربه: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى * إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّهُ
يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى}.
ومن هذا ـ أي مما يكون الحديث قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه ـ قصة عمر بن الخطاب مع
عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم في
حاجة، فأجنبا جميعاً عمار وعمر. أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة
الماء، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأجل أن يشمل بدنه التراب، كما كان يجب
أن يشمله الماء وصلَّى، أما عمر رضي الله عنه فلم يصل.. ثم أتيا إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلّم فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك
هكذا» ـ وضرب بيديه الأرض مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.
وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر، وفيما قبل ذلك، ولكن عمر
دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما
بعثنا رسول الله في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في الصعيد،
فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا». ولكن عمر لم
يذكر ذلك وقال: اتق الله يا عمار، فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله عليَّ من
طاعتك أن لا أُحدِّث به فعلت، فقال له عمر: نوليك ما توليت ـ يعني فحدِّث به الناس
ـ فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في
حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحصل
بينه وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر، فأورد عليه قول عمار
لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار، فقال أبو موسى: دعنا من
قول عمار، ما تقول في هذه الآية؟ ـ يعني آية المائدة ـ فلم يقل ابن مسعود شيئاً،
ولكن لا شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجُنُب يتيمم، كما أن المحدث
حدثاً أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي، فيقول
قولاً يكون به معذوراً لكن مَن علِم الدليل فليس بمعذور. هذان سببان.
السبب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.
فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب، والثاني من السُّنَّة:
1 ـ من القرآن، قوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ
مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً...} اختلف العلماء رحمهم الله في معنى
{أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ} ففهم بعضٌ منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون:
أن المراد به اللمس المثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به الجِماع، وهذا الرأي
رأي ابن عباس رضي الله عنهما.
وإذا تأمَّلت الآية وجدت أن الصواب مع مَن يرى أنه الجِماع، لأن الله تبارك وتعالى
ذَكَرَ نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله:
{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}. أما الأكبر فقوله: {وَإِن
كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ...} الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يُذكر
أيضاً موجبا الطهارتين في طهارة التيمم، فقوله تعالى: {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُم
مِّنَ الْغَائِطِ} إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر.. وقوله: {أَوْ لَـمَسْتُمُ
النِّسَآءَ} إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر.. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى
اللمس، لكان في الآية ذِكْر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر. وليس فيها ذكر
لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين
فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مسَّ إنسان ذكرٌ بشرةَ الأنثى
انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض، والصواب عدم الانتقاض
في الحالين، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب
إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضاً.
2 ـ من السُّنَّة: لمَّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من غزوة الأحزاب، ووضع
عدَّة الحرب جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة، فأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلينَّ أحدٌ العصر إلا
في بني قريظة» الحديث، فقد اختلف الصحابة في فهمه. فمنهم مَن فهم أن مراد الرسول
المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلمَّا حان وقت
العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها.
ومنهم مَن فهم: أن مراد رسول الله ألا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة فأخَّروها
حتى وصلوا بني قريظة فأخرجوها عن وقتها.
ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها؛ لأن النصوص في وجوب الصلاة في
وقتها محكمة، وهذا نصٌ مشتبه. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم.. إذن من
أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الرابع.
السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم
بالناسخ، فيكون الحديث صحيحاً والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم
بنسخه، فحينئذٍ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ.
ومن هذا رأى ابن مسعود رضي الله عنه.. ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في
أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في
أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. وثبت في صحيح
البخاري وغيره النسخ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ، فكان يطبق
يديه، فصلَّى إلى جانبه علقمة والأسود، فوضعا يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله
عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق.. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا
يكلف إلا وسع نفسه.. قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن
نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ}.
السبب السادس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو
إجماع. بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من
نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الأئمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع، ولكنه
عند التأمل لا يكون إجماعاً.
ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد. وآخرون قالوا:
أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان
من حوله اتفقوا على رأي، ظنَّ أن لا مخالف لهم، لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص،
فيجتمع في ذهنه دليلان النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح، والنظر
الصحيح فيحكم أنه لا خلاف، وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح
عنده، والأمر قد كان بالعكس.
ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في رِبا الفضل..
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»، وثبت عنه
في حديث عبادة بن الصامت وغيره: «أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة».
وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة. أما ابن
عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعاً من القمح
بصاعين يداً بيد، فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط.
«وإذا بعت مثلاً مثقالاً من الذهب بمثقالين من الذهب يداً بيد» فعنده أنه ليس ربا.
لكن إذا أخَّرت القبض، فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا..
لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، ومعلوم
أن (إنما) تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دلَّ عليه
حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «مَن زاد
أو استزاد فقد أربى».
إذاً ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدلَّ به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه
يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضاً في الفضل، بأن نقول:
إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الجاهلية والذي وَرَدَ فيه قوله تعالى:
{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَـفاً
مُّضَـعَفَةً}. إنما هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم،
ولهذا ذهب ابن القيّم في كتابه «إعلام الموقعين» إلى أن تحريم ربا الفضل من باب
تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد.
السبب السابع: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل
استدلالاً ضعيفاً. وهذا كثير جداً، فمن أمثلته: أي أمثلة الاستدلال بالحديث
الضعيف: ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان
ركعتين، يقرأ فيهما بالفاتحة، ويُسَبِّح خمس عشرة تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود
إلى آخر صفتها التي لم أضبطها، لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن صلاة
التسبيح بدعة مكروهة، وأن حديثها لم يصح، وممن يرى ذلك الإمام أحمد وقال: إنها لا
تصح عن النبي صلى الله عليه وسلّم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن حديثها كذب على
رسول الله، وفي الحقيقة مَن تأمَّلها وجد أن فيها شذوذاً حتى بالنسبة للشرع، إذ إن
العبادة إما أن تكون نافعة للقلب، ولابد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت
وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة، وهذه في الحديث الذي جاء
عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير
له في الشرع، فدل على شذوذها سنداً ومتناً، وأن مَن قال إنها كذب، كشيخ الإسلام
فإنه مصيب، ولذا قال شيخ الإسلام: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة.
وإنما مثَّلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه
البدعة أمراً مشروعاً، وإنما أقول بدعة، أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس
لأننا نعتقد أن كل مَن دان لله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو سُنَّة رسوله فإنه
بدعة.
كذلك أيضاً مَن يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال. الدليل قوي لكنه من حيث
الاستدلال به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»..
فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أمّ الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة له
ـ أي لا يحتاج إلى ذكاة إذا أُخرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة من
تذكيته بعد موته.
ومن العلماء مَن فهم أن المراد به ـ أي بالحديث ـ أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، تكون
بقطع الودجين وإنهار الدم ـ ولكن هذا بعيد والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد
الموت.
ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل».
ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت.
هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة، وبحر لا ساحل له.. ولكن بعد
هذا كله ما موقفنا؟
وما قلته في أول الموضوع: أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة
والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون
ويقولون مَن نتبع؟
تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد
وحينئذٍ نقول: موقفنا من هذا الخلاف، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم
موثوقون علماً وديانة، لا مَن هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأننا لا
نعتبر هؤلاء علماء، ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم.. ولكننا نعني
به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم، موقفنا من هؤلاء يكون على
وجهين:
1 ـ كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف
الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف، وبما لم نذكره، وهو كثير يظهر لطالب العلم
حتى وإن لم يكن متبحِّراً في العلم.
2 ـ ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماماً لا
يخرج عن قوله، ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب، أم يتبع ما ترجَّح
عنده من دليل ولو كان مخالفاً لِمَا ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟
الجواب هو الثاني، فالواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف مَن خالف
من الأئمة. إذا لم يخالف إجماع الأمة، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله صلى الله
عليه وسلّم يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان، فقد شهد لغير الرسول
بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله
عليه وسلّم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويُترَك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة مَن الذي يستطيع أن يستنبط
الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا في الحقيقة
ليس بجيد، نعم من حيث الهدف والأصل هو جيد؛ أن يكون رائد الإنسان كتاب الله
وسُنَّة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل مَن عرف أن ينطق بالدليل، وإن لم يعرف
معناه وفحواه، فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد
الخلق والمجتمع. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ عالِم رزقه الله عِلماً وفهماً.
2 ـ طالب علم عنده من العلم، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحِّر.
3 ـ عامي لا يدري شيئاً.
أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى
الدليل عنده مهما خالفه مَن خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام
رسوله.
أما الثاني: الذي رزقه الله علماً ولكنه لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ
بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك، وألا
يقصِّر عن سؤال مَن هو أعلى منه من أهل العلم؛ لأنه قد يخطأ، وقد لا يصل علمه إلى
شيء خصَّص ما كان عامًّا، أو قيَّد ما كان مطلقاً، أو نَسَخَ ما يراه محكماً. وهو
لا يدري بذلك.
أما الثالث: وهو مَن ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ}، وفي آية أخرى: {إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ
* بِالْبَيِّنَـتِ وَالزُّبُرِ}. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن
مَن يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكلٌّ يقول: إنه عالم، أو كلٌّ يقال عنه: إنه
عالم، فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن تتحرى مَن هو أقرب إلى الصواب فتسأله
ثم تأخذ بقوله، أو نقول: اسأل مَن شئت ممَّن تراه من أهل العلم، والمفضول قد
يوفَّق للعلم في مسألة معيَّنة، ولا يوفَّق مَن هو أفضل منه وأعلم ـ اختلف في هذا
أهل العلم؟
فمنهم مَن يرى: أنه يجب على العامي أن يسأل مَن يراه أوثق في علمه من علماء بلده،
لأنه كما أن الإنسان الذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه مَن يراه أقوى معرفة
في أمور الطب فكذلك هنا؛ لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك مَن تراه
أقوى فكذلك هنا يجب أن تختار مَن تراه أقوى علماً إذ لا فرق.
ومنهم مَن يرى: أن ذلك ليس بواجب؛ لأن مَن هو أقوى عِلماً قد لا يكون أعلم في كل
مسألة بعينها، ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا
يسألون المفضول مع وجود الفاضل.
والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل
الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطأ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب
فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية، والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب
لعلمه وورعه ودينه.
وأخيراً أنصح نفسي أولاً وإخواني المسلمين، ولاسيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان
نازلة من مسائل العلم ألا يتعجَّل ويتسرَّع حتى يتثبَّت ويعلم فيقول لئلا يقول على
الله بلا علم.
فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلِّغ شريعة الله كما ثبت عن رسول
الله صلى الله عليه وسلّم «العلماء ورثة الأنبياء».
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم «أن القضاة ثلاثة: قاض واحد
في الجنة وهو مَن عَلِمَ الحق فحكم به» كذلك أيضاً من المهم
إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلِّمك لاسيما في
الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس.
وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمَن سئل عن مسألة أن يُكْثِر من الاستغفار،
مستنبطاً من قوله تعالى: {إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَـبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ
تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُوراً رَّحِيماً}، لأن الإكثار من الاستغفار
يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل كما قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـقَهُمْ لَعنَّـهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا
ذُكِرُواْ بِهِ}، وقد ذُكِرَ عن الشافعي أنه قال:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي
فلا جرم حينئذٍ أن يكون الاستغفار سبباً لفتح الله على المرء.
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو
الوهَّاب.
والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيراً...
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.









